تبعية الانحراف في كتاب (( السيدة مريم في القرآن الكريم ))
عنون الكاتب الفرنسي «غي سورمان» لكتابه المترجم عن «المؤسسة العربية للأبحاث
والنشر» الدائر حول الحداثيين في العالم الإسلامي بــ«أبناء رفاعة الطهطاوي»، ولو
أردنا العنونة للنسب الفكري لأرباب القراءة الحداثية الأدبية للقرآن الكريم لعنونا
له بــ«أبناء المستشرقين».
فما زال الاستشراق الكلاسيكي والمعاصر كلاهما موردًا تستقي منه القراءات الحداثية
العربية للقرآن الكريم، وتعد القراءة الأدبية التي تعمد إلى التسوية بين النص
القرآني والنص الأدبي، التي قدمها طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي» موظِفًا
فيها المنهج التاريخي الغربي، أولى تلك القراءات وأشهرها على الإطلاق. وعلى نهج طه
حسين تشكلت الكتابات اللاحقة والموصوفة بالمحاولات التجديدية، من مثل كتابات أمين
الخولي وتلميذه محمد أحمد خلف الله ومن نحا نحوهم مع اختلافات بين تلك القراءات لا
تمس منطلقاتها الأساسية.
ومن أحدث القراءات الأدبية المعاصرة للقرآن الكريم والمصنَّفة ضمن القراءات
الحداثية التجديدية للقرآن الكريم دراسة للباحثة اللبنانية حُسن عبود، وهي نسوية
وناشطة في الحوار الإسلامي المسيحي. نُشرت الدراسة بعنوان: «السيدة مريم في القرآن
الكريم: دراسة أدبية». وأصل الدراسة رسالة دكتوراه قدمتها الباحثة في جامعة تورنتو
في كندا، وترجمتها المؤلفة بنفسها إلى اللغة العربية وطبعت في كتاب أصدرته دار
الساقي عام 2010م، وذكرت فيه المؤلفة من سبقوها لهذا النوع من الدراسات كأمين
الخولي ونصر حامد أبو زيد، كما صرحت فيه المؤلفة بإضافتها الجديدة للمحاولات
السابقة حيث تعلَّق اختيارها لموضوع الدراسة بالنسوية والجندر وتجديد نظرة المسلمين
للجندر.
الاستشراق منطلقًا ومضمارًا:
لم تتردد المؤلفة في إبراز مرجعيتها الاستشراقية وعرضت مستنداتها الاستشراقية
باعتبارها مراجع موضوعية، متجاهلةً الاعتراضات النقدية الإسلامية والغربية لما
تضمنته تلك المراجع من أخطاء منهجية وتاريخية حول القرآن الكريم، فذكرت المؤلفة
عددًا من المؤلفات والمقالات الاستشراقية الكلاسيكية التي تعد بحسب قولها: «من أهم
المراجع الغربية الأساسية لطلاب وطالبات علوم القرآن»،
كالفيلولوجي التاريخاني ثيودور نودلكه في كتابه «تاريخ القرآن»، ومقالة ألفورد ولش
«القرآن» في الموسوعة الإسلامية، ومقدمة بال وواط للقرآن، وكتاب آرثر جفري «القرآن
ككتاب مقدس» الذي وصفته بـ«الرائد».
كما اعتمدت بصورة أساسية على مؤلفات المستشرقة الألمانية المعاصرة أنجليكا نويفرت،
فأقرت حُسن عبود أنها حذت حذوها في تحليلها الكولومتري للآيات القرآنية المستخدم
أصلًا في تحليل الإنشاد الديني اليوناني، وفي قراءاتها للآيات المكية، وسنشير في
المحاور المقبلة لتواصل عبود المستمر مع رؤى أنجليكا وتنزيلها على قراءتها لقصة
مريم في القرآن، والجدير بالذكر أن أنجليكا قدمت من ألمانيا إلى كندا لمناقشة رسالة
عبود.
أما بقية مراجع عبود المصنفة ضمن التراث الإسلامي وغيره، ككتابات السيوطي والشعر
العربي فموظفة في خدمة الرؤية الاستشراقية ولا تخرج عن مضمارها قيد فكرة، وحين
تختلف المؤلفة مع آراء بعض المستشرقين فاختلافها كاختلاف المقلدين للمجتهدين داخل
المذهب نفسه، وينسحب هذا على توظيفها للأناجيل الرسمية والمنحولة وأساطير الثقافات
الوثنية، في دراستها للقرآن الكريم فكلها تُستَحضر لتأكيد المقولات الاستشراقية
حوله.
ولا تخفي المؤلفة بالمثل عتادها المنهجي، فتعترف بتطبيق النظريات الحداثية على النص
القرآني، وعلى رأسها المنهج التاريخي الذي يسوي بين النص القرآني والنصوص الأدبية،
كما تطبق نظرية التناص بصياغة جوليا كريستيفا بين النص القرآني ونصوص الأناجيل
الرسمية والمنحولة، وتتخذ من الجندر[1]
معيارًا تحليليًّا في قصة مريم عليها السلام في القرآن الكريم، وتوظف النقد النسوي
الذي عبرت عنه أيضًا بالشك النسوي في الموقف الثقافي من نبوة مريم، الأمر الذي
وصفته المؤلفة بمشاركة مريم على أعلى مستوى ديني، كما تطبق المؤلفة التحليل النفسي
في قراءتها للنص القرآني.
وسنعرض في المحاور التالية أبرز الانحرافات التي تضمنها الكتاب، إذ لن تفي الصفحات
المقبلة بذكر كل ما حواه الكتاب من أخطاء ومغالطات وتناقضات علمية وشرعية وتاريخية.
أصول الانحراف:
تتبدى الانحرافات التي تضمنها كتاب السيدة مريم في القرآن الكريم في المقولات التي
تأسست عليها الدراسة، والنتائج المترتبة عليها.
وتتمثل تلك المقولات في الرؤى الاستشراقية التي انطلقت منها المؤلفة ومن أبرزها
وأخطرها، مقولتان:
المقولة الأولى:
بشرية النص القرآني:
نفي المصدر الإلهي للقرآن ونسبته للرسول
صلى الله وعليه وسلم
مقولة استشراقية شهيرة، وقد قال بها
-
من مراجع حسن عبود من المستشرقين
-
كل من بال وآرثر جيفري وكذا نولدكه شيخ المستشرقين الألمان الذي تصفه المستشرقة
أنجليكا وينفرت بـ«حجر كنيستنا»،
والذي يرى أن النص القرآني وضعه وطوَّره محمد (صلى الله وعليه وسلم)، وهذا ما قالت
به أنجليكا وينفرت زاعمة أن القرآن الكريم مثله مثل العهدين
(التوراة
والإنجيل)
«كلام
نبوي».
ويُلحظ أثر هذه المقولة جليًّا في تصريح حسن عبود الحذِر والمشكك في أكثر من موضع
في كتابها بتطوير النبي
صلى الله وعليه وسلم
للقرآن، ومنه نقلها لكلام أنجليكا حول المصادر المتعددة للقرآن، ثم تعقيب عبود
بقولها:
«بغرض الاستفادة والاستنتاج...
نتساءل عما نعرفه عن دور صاحب البلاغ الرسول محمد
(صلى
الله وعليه وسلم)
حين كان يجمع الوحي بنفسه ويطوره في مرحلة متأخرة ليشكل السور الطويلة للمصحف
المكتوب».
ويبدو تلبيس عبود واضحًا في خلطها بين مسألة ترتيب النبي
صلى الله وعليه وسلم
للآيات في السور وهي مسألة أجمع فيها المسلمون على أن ترتيب الآيات بتوقيفه صلى
الله وعليه وسلم، وبين مقولة المستشرقين بتطوير النبي
صلى الله وعليه وسلم
للقرآن، أي التدخل في مضامينه، وهي مقولة باطلة بلا شك.
المقولة الثانية:
تعدد المصادر التي تكوّن منها النص القرآني:
يدعي المستشرقون أن النبي
صلى الله وعليه وسلم
تأثر بالبيئة والوسط الثقافي الذي كان يعيش فيه وقد تركت هذه البيئة بصماتها في
القرآن المنسوب للنبي صلى الله وعليه وسلم، وزعم بعضهم أن القرآن ما هو إلا
اقتباسات من التوراة والإنجيل، ومنهم من زعم تضمن القرآن للأساطير الوثنية، وتضيف
أنجليكا إلى من سبقها من المستشرقين كنودلكه الذي تمثل امتدادًا له قولها أن النص
القرآني نصٌ حواري تواصلي «بين نبي قائل كريزمائي والمتلقي جمهوره المؤمن»،
وليس نصًا أحادي الصوت كما يرى نودلكه أي صوت محمد فقط، بل حوى أصواتًا متعددة
عبَّرت عن الجماعة والتاريخ والثقافات المختلفة في ذلك العصر.
وعلى النهج الأنجليكي نفسه سارت حُسن عبود وجهدت في إثباته، فتراها تقول عن الإعاذة
في قوله تعالى:
{أُعِيذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ}
[آل
عمران:
36]
إنها تعني العصمة من الخطيئة الأولى وهي «فكرة تولدت من الفترة المسيحية المبكرة».
وتدعي بعد مقارنة قصة مريم في القرآن والأناجيل المنحولة أن الإضافة الوحيدة للقرآن
في هذا الشأن هي ولادة عيسى تحت الشجرة والتي تعتبر
«إضافة
قرآنية جديدة إلى الموتيفات المسيحية وإبداعًا من جانب القرآن الكريم».
أما كيفية ظهور الأثر المسيحي في القرآن فيعود بحسب قول المؤلفة
«إلى
نوع البيئة الثقافية المسيحية التي تفاعل معها المسلمون الأوائل وصاحب البلاغ خاصة
في محيط مكة»،
والتي كشف عنها البحث من خلال
«أسماء
الشخصيات الكتابية في غريب القرآن في سورة مريم»،
ويبدو أن المؤلفة قد حذفت الجزء الذي تناولت فيه أسماء تلك الشخصيات من البحث في
الترجمة العربية لعدم تطرقها إليه في الكتاب!
وجوه الانحراف:
التسوية بين القرآن والنصوص الأخرى:
القارئ لكتاب السيدة مريم لحُسن عبود لا يلحظ فحسب تسوية في التعبير عن الله سبحانه
وتعالى متكلمًا بالقرآن وبين أصحاب النصوص الأخرى، حيث تم التعبير عنهم جميعًا
بـ«صوت السرد»، بل يلحظ كذلك ثلاثة أنواع من التسوية بين القرآن والنصوص الأخرى،
وهي:
التسوية بين القرآن والأدب الجاهلي، والتسوية بين القرآن والكتب السماوية المحرفة،
والتسوية بين القرآن والأسطورة.
ففي ربط المؤلفة بين قصة مريم والتراث العربي الجاهلي تذكر عبود أن تمني مريم للموت
ودعاءها على نفسها به
«يستعيد
تراثًا أدبيًّا رثائيًّا قديمًا لرجال ونساء العرب الشعراء والشواعر والخنساء واحدة
منهن».
لكنها تهتم بشكل خاص بالتفسير الميثي
(الأسطوري)
لقصة مريم وتطوراته اللغوية في القرآن فتراها تقول في قوله تعالى:
{فَأَجَاءَهَا
الْـمَخَاضُ إلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ}
[مريم:
23]
«يمثل
المخاض أو جذع النخلة كمحرك للفعل، مرحلة في اللغة عندما كانت المفاهيم الميثية
(الأسطورية)
تُلقي صفات إنسانية على النبات والملائكة والآلهة».
كما تطرح المؤلفة من المنظور نفسه تأويلًا أسطوريًّا متوسلةً بالتحليل اللغوي لكلمة
غلام في قوله تعالى:
{لأَهَبَ
لَكِ غُلامًا زَكِيًّا}
[مريم:
19]
حيث يعني الجذر غلم:
طلب النكاح، وعليه فإن
«استخدام
النص لمصطلح غلام مرتين في القصة يشير بطريقة غير مباشرة إلى قوة الخصوبة»
كما تذكر المؤلفة، لتلفت النظر بعدئذ للارتباط الواقع بين «الأنثى والشجرة والمياه»
في الحضارات القديمة، باعتبار هذا الارتباط ممثلًا لأقدم صورة من صور الخصوبة في
تلك الحضارات، والذي يبدو في التصاوير الجدارية الفرعونية الوثنية.
وتضيف المؤلفة: «تقوم مريم برحلة منفردة لتحمل بأمر من الله
{قَالَ
كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ}
[مريم:
٩]،
ولتلد وحدها في مكان قفر لنحتفل بالنهاية بالأم المثال، تحت الشجرة التي تعطي الرطب
وفوق المياه التي تتفجر ينابيعها، لتبقى الأنثى على مستوى الواقع كما الميثي
الأسطوري، صورة قوية لغلبة الخصوبة على الجفاف، أو نصرة الحياة أمام الموت.
فتقوم مريم برحلة تفجر خصوبة الأنثى التي تعتبر مقدسة عند العرب كما يظهر ذلك في
الشعر العربي الجاهلي».
وتؤكد المؤلفة الحضور الأسطوري في سورة مريم بقولها:
«إن موتيف قصة مريم الذي حول الصحراء إلى واحة ارتبط في سياق السورة ببنية ميثية».
وتشرح هذه الفكرة ممارسة التأويل الإسقاطي الخيالي بقولها:
«تدمج مريم الأنثى وهي تهز الشجرة لإطعام نفسها بقوة الشجرة التي تعطي أيضًا الثمر
والحياة.
ونستطيع أن نتخيل هذا الإدماج بين مريم والنخلة في صورة للآلهة التي تعطي ثمرها في
عمل فني مصري من السلالة الثامنة عشرة تعتبر من أكثر الصور دراماتيكية للدلالة على
أمومة الشجرة».


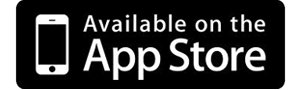
كما تقدم المؤلفة تأويلًا من أساطير مصر القديمة لقوله تعالى:
{فَنَادَاهَا
مِن تَحْتِهَا}
[مريم:
24]
بأن المراد بتحتها في الآية هو من
(بطنها)؛
ذلك أن
«التكليم
من بطن الأم ورد كثيرًا في مصر القديمة حين كان يتكلم الملِك الجنين من بطن الأم».
وتتبع حُسن عبود خطى أنجليكا حذو القذة بالقذة، فتضيف بصراحة تامة قولها بعد ما
وصفته بمنطق التضاد في سورة مريم:
«نتذكر في شرح منطق التضاد هذا كلمات نورثروب فراي الذي يعلمنا أن البُنى الميثية
الأسطورية تستمر بإعطاء شكل الاستعارات والبلاغة لأنواع متأخرة من البُنى، مع أن
رصيد الكتب المقدسة كما تقول الأستاذة نويفرت، هو في وساطتها كوسيلة لإزاحة الأسطرة
بامتياز».
وتنتهي المؤلفة في خاتمة كتابها بذكر رأيها الصريح حول بشرية القرآن الكريم، فتقول:
«نستطيع أن نصف نوع السورة بأنه مزيج من اللترجيا المسيحية والشعرية الدينية
العربية.
وهذا الذوبان المدهش لا يمكن أن يولد إلا في محيط ثقافي يعتمد على الشفاهية مصدرًا
(للوحي)
والمعرفة».
وتترتب على هذه المقولات الاستشراقية التي تأسس عليها كتاب السيدة مريم في القرآن
الكريم نتائج متعددة، أبرزها:
1-
رفع القداسة عن القرآن:
القول ببشرية القرآن وأنه نتاج محيط متعدد الثقافات ينتهي إلى رفع القداسة عنه،
وهذا ما أكدته أستاذة حُسن عبود أنجليكا نويفرت على المستوى النظري في كتابها:
«القرآن بوصفه نصًا من العصور الكلاسيكية المتأخرة:
قراءة أوروبية»، والذي وصفه الباحث المغربي رشيد بو طيب في مقالته المنشورة في
صحيفة الحياة بأنه ممارسة لهرمنيوطيقا الأصل، وعلَّق عليه بقوله: «إن كتاب نويفيرت
وعلى رغم ادعائه أنه يطلب تجاوز المركزيتين الإسلامية والغربية، ينتمي في رأيي إلى
القرن التاسع عشر الأوروبي وروحه الوضعية، مع بعض توابل ما بعد حداثية يفرضها
السياق، وبلغة أخرى إنه ينتمي إلى أدبيات الإلحاد».
أما على المستوى العملي فتتبنى أنجليكا مشروع: «الأرشيف الضائع» الذي يحاول اكتشاف
النسخ الأخرى للقرآن، بحثًا عن أدلة تثبت أن القرآن نص يعود إلى أصل غير إلهي أو
أصل غير مفارق وقابل للتغيير، وذلك لإعطاء القرآن القيمة التاريخية التي أعطيت
للتوراة.
وهذا الهدف هو ما اشتغلت عليه حُسن عبود في كتابها، وإن حذفت جزءًا من رسالتها في
الترجمة العربية ومزجت تصريحاتها المنشورة في الكتاب بكلام موهم، وهذه النتيجة هي
ما يتوصل إليه قارئ كتاب عبود، وهي أيضًا ما أشار إليه مقدم كتابها رضوان السيد
بقوله:
«هناك
أحداث أو وقائع أو رموز متشابهة، لكن التركيب مختلف، والتوظيفات مختلفة، والأولويات
مختلفة، والنتائج مختلفة، بيد أن الأساس
(الإنساني)
العميق يظل واحدًا».
2-
تغييب الإعجاز الغيبي في القرآن:
فما دام القرآن مجرد صدى للكتب المقدسة والأساطير الوثنية فما الجديد الذي جاء به
القرآن، وما قيمة تصحيح القرآن للعقائد الباطلة المنبنية على روايات باطلة للإنجيل
حول ألوهية عيسى بن مريم عليه السلام، ما دام القرآن بحسب دراسة عبود ليس سوى وعاء
يحوي مزيجًا من الثقافة الشفوية لمحيطه، وما جاء به من حقائق مخالفة للكتب الأخرى
ليس إلا انحرافًا أخيرًا عنها في مسار الرواية.
وهذا يعيدنا لأستاذة حُسن عبود مرة أخرى فأنجليكا نويفرت ترى أن القرآن نص شفوي
ولذا تلفت النظر إلى الثقافة الشفوية السائدة في محيطه، وهي تعيد بهذا إنتاج تهمة
المستشرقين للنبي
صلى الله وعليه وسلم
بالنقل من كتب السابقين لاصطدام هذه التهمة بأميته
صلى الله وعليه وسلم
فتعيد أنجليكا صياغة الشبهة وطرحها مجددًا لتثبتها عن طريق الثقافة الشفوية التي لا
يحتاج الأمي في تداولها لتعلم القراءة والكتابة، وهذا الرأي فضلًا عن كونه تكذيبًا
لقوله سبحانه:
{ذَلِكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ}
[آل
عمران:
٤٤]،
وقوله:
{تِلْكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إلَيْكَ
مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ}
[هود:
49]،
فهو مخالف للواقع التاريخي، وفي هذا يقول ابن تيميه
-
رحمه الله
-: «وقد
علم بالتواتر أن المشركين من قريش وغيرهم، لم يكونوا يعرفون هذه القصص، ولو قدر
أنهم كانوا يعرفونها، فهم أول من دعاهم إلى دينه فعادوه وكذبوه، فلو كان فيهم من
علمه أو يعلم أنه تعلم من غيره لأظهر ذلك، ولو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها
صلى الله وعليه وسلم
من أهل الكتاب مع عدوانهم له، لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه ولو أظهروا ذلك، لنقل
ذلك وعرف، فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها».
أما حديث عبود عن قوة الخصوبة ورموزها الوثنية وحول تقديس العرب لقوة الخصوبة
فقراءة تأويلية إسقاطية لا ترقى لمرتبة الحجة، وأما رموز المياه والشجر فأيقونات
طبيعية للبيئة المحيطة بالإنسان التي كان يعظمها الوثنيون وينسبون إليها قوى خارقة،
ووجودها في القرآن لا يزيح أساطيرهم ليستوعبها ويعيد صياغتها بصورة أخرى كما تشير
المؤلفة السائرة على نهج أستاذتها المستشرقة، وهو كوجود الشمس في القرآن، فهل كل
حديث عن المخلوقات الكونية المحيطة بالإنسان في القرآن يؤوَّل هذا التأويل
الاستشراقي الساذج، ليصبح القرآن مزيجًا من البوذية واليهودية والنصرانية وكل ديانة
وثنية ساقطة أيضًا، مع فارق كون تلك المخلوقات المذكورة في القرآن مخلوقة لله
ومسخرة للإنسان وبين كونها معبودات للمشركين.
إن إسقاط التفاسير الأسطورية على القرآن أو أسطرة القرآن ليس جديدًا وهو أنسنة
واضحة للنص القرآني وهبوط بمستواه إلى أدنى مرتبة من مراتب النصوص الإنسانية، فلا
تضع المؤلفة القرآن بمصاف النصوص الإنسانية العبقرية ولا الإبداعية، بل بمرتبة
النصوص الأسطورية البدائية التي تدعي عبود أن القرآن يستبطنها محاولًا تجاوزها،
وذلك عبر تتبع المؤلفة للطُرز البدائية في النص القرآني أو ما سمته بـ«الأرختايب»
وهي الأنساق العميقة اللاواعية لدى الإنسان ومن ذلك أرختايب «الأُم».
3-
نسبة النقص والضعف التاريخي والفني للقرآن:
ومرد النقص والضعف التاريخي لعدم اهتمام القرآن بالتسلسل الزمني
(الكرونولوجي)
للأنبياء، وهذه الرؤية ليست نتاج بحث المؤلفة بل هي مقولة استشراقية معروفة لدى
الباحثين في الأدبيات الاستشراقية، وقد تشكلت هذه المقولة نتيجة جعل التوراة
والإنجيل مقياسًا يحاكم إليه القرآن الفريد والمعجز بأسلوبه وحقائقه، وأما الضعف
الفني فلأن القصص أو السرد الفني ليس هدفًا مجردًا للقرآن وله أغراض أخرى كما تذكر
المؤلفة، وتضيف أن القرآن
«يجهض
متعة السرد بهدف الحجاج العقدي»،
ولذا فتتمة القصة وتفاصيلها المطوية في القرآن برأي المؤلفة لا تُطلب من القرآن
وحده ولا بد من طلبها في المصادر الأخرى التي شكَّلت النص القرآني، لعدة أسباب
تذكرها بقولها:
«نخبرك مسبقًا بأن سيناريو القصة في هذا القرآن جاء مختصرًا عما هو عليه في إنجيل
يعقوب التمهيدي، إما لأن القرآن يفترض أن القصة كاملة وهي معروفة عند المتلقي، أو
لأن هناك أسبابًا أخرى تستدعي الحذف والإيجاز اللذين يعدان أصلًا ميزة أسلوب خطاب
السرد القرآني».
وهذه المقولة الاستشراقية التي تلبس حقًا بباطل لا تختلف كثيرًا عما أجابت به
أنجليكا محاورها حين سُئلت في حوار صحفي أجري معها بوصفها خبيرة في القرآن وتفسيره،
وتم نشر الحوار في موقع قنطرة الألماني، ما هي النصيحة التي تقدمينها لشخص لم يطلع
حتى الآن على الدين الإسلامي ويود الانشغال بالقرآن للمرة الأولى؟
فقالت:
«هذه نقطة انطلاق غير مواتية أبدًا إن لم يكن مطلعًا على الكتب المقدسة الأخرى،
للأسف لم تعد عمومًا لدى القارئ المعرفة التي كان يملكها من استمعوا إلى النبي،
فهؤلاء كانوا مثقفين، وكانت لديهم دراية بمعارف الإنجيل ومعارف زمنهم الفلسفية التي
لا نملكها اليوم».
وهذه مغالطة تاريخية مفضوحة، فلم يكن العلم بمعارف الإنجيل والمعارف الفلسفية
الأخرى غالبًا على العرب الذي عُرفوا بكونهم أمة أمية في ذلك الوقت.
4-
اتهام القرآن بالتحيز ضد المرأة:
مفهوم النظام الأبوي والمفهوم المقابل له المعروف بالنظام الأمومي من المفاهيم
التحليلية الأساسية في الأدبيات النسوية، ويعرَّف النظام الأبوي بأنه: «نظام يسوده
الرجل، وتُفرض فيه السلطة من خلال المؤسسات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية،
والدينية»،
وقد وظفته النسويات في تتبع سيطرة الرجال على النساء في المجتمعات الإنسانية.
وفي مشابهة لنهج نسويات أخريات وبناء على المعطيات الاستشراقية نفسها ترى حُسن عبود
أن النسب الأمومي المرتبط بالنظام الأمومي هو الغالب على مجتمع الجزيرة قبل
الإسلام، وأن النظام الأبوي حلَّ محل النظام الأمومي بعد هجرة النبي
صلى الله وعليه وسلم
إلى المدينة المنورة ويمكن ملاحظة هذا التحول بالنظر في السور المنزلة في العهد
المكي فـ«مع إقامة المجتمع الإسلامي الأول في المدينة ربما جاء الأمر بالتشديد على
النسب الأبوي لأول مرة».
وحول ما تصفه عبود بالتحيز اللغوي في قوله تعالى:
{وَلَيْسَ
الذَّكَرُ كَالأُنثَى}
[آل
عمران:
36]
تقول:
«وما
يلفت النظر في هذه الجملة الاعتراضية أنها لا تبدأ كما تقتضي القاعدة منطقيًّا
بتشبيه الأنقص بالأكمل، كأن يقال وليست الأنثى كالذكر، بل تبدأ بالذكر لتلغي تشبيهه
بالأنثى كما يظهر في التشبيه
{لَسْتُنَّ
كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ}
[الأحزاب:
32]،
ويُبرر اللغويون هذا التركيب بأن ذكر الأنثى قبل الذكر في تركيب الجملة غير مستحب
في بناء جملة التشبيه، ويدل هذا الموقف المتحيز للذكر في التحرير على واقع عرفي
سرعان ما يلغى بسبب قبول الله لمريم في المحراب كقبول الذكر، مما يعني أن اللغة تعي
جيدًا صناعة مدلولاتها».
وحول التركيب النحوي للقرآن تقول: «التركيب النحوي للغة القرآنية يعكس ربما حركة
التفكير للمتلقين للغة، والتي لها علاقة بالمركب الاجتماعي
(جندر)
وهذا التوضيح ضروري بالنسبة لدراسة النصوص التي تعكس مواقف لغوية ونفسية
وأنثروبولوجية تميز بها بين الأنثى والذكر».
وتضيف: «ونتعجب بصدد هذا التحسس الجندري، هذا التحسس في نفي الأنوثة عن الملائكة
يدفعنا إلى التساؤل عن عدم التشدد في ذكر الملَك بالمفرد لا بالجمع، والمقصود أن
اللغة أبطأ على التغيير في مفاهيمها من الفكر السابق على التغيير في مفاهيمه، وهذا
يفسر الحضور القوي للأنثوي في السور المكية».
ما الذي تعنيه المؤلفة بهذه الكلمات؟ تعني هذه الكلمات باختصار أن السور المكية
التي نزلت قبل احتكاك النبي
صلى الله وعليه وسلم
باليهود في المدينة كانت تعبر عن نظام أمومي أي عن ثقافة تقديس الأنثى الغالبة على
الثقافة العربية قبل الإسلام كما ادعت المؤلفة، وحين انتقل النبي للمدينة تأثر
باليهود ذوي الثقافة الأبوية الذكورية المتحيزة للذكر، أي أن القرآن الذي وضعه
النبي
صلى الله وعليه وسلم
وطوره تأثر بتلك الثقافة وسجل تقهقرًا واضحًا في موقفه من المرأة على صعيد اللغة
والمفاهيم.
5-
الإشارة إلى تفوق الأناجيل المنحولة على القرآن تجاه المرأة:
وهذا ما ذكرته حُسن عبود بوضوح لا يتطلب مزيد بيان بعد عرضها نصًا إنجيليًّا
منحولًا، ونصًا من القرآن، بشأن امرأة عمران، وقالت:
«الفرق بين النصين المعنيين أن صوت السرد في الأول يقدم نذر حنة لله سيان عندها
أكان المولود ذكرًا أم أنثى فهو نذير، بينما يعترض صوت السرد في الثاني ليعرض مسألة
تفضيل الذكر على الأنثى في النذر مما يدل على أن الخطاب القرآني يأخذ في الاعتبار
عرفًا من الأعراف الموجودة في اللاوعي الجماعي العربي».
6-
تاريخية النص القرآني:
تفترض جميع المقولات السابقة أن النص القرآني مثله مثل التوراة والإنجيل نصٌ محصور
بالتاريخ والجماعة والتقاليد الثقافية التي احتضنته، والتي تفاعل معها النبي
صلى الله وعليه وسلم
وأسهمت في إنتاج النص وتطوره، ولذا فقد شهد القرآن تحولًا من عصر أمومي مجَّد
المرأة إلى آخر أخذ بتعزيز قيم النظام الأبوي، لكن القرآن لم يفقد طاقته التأويلية
ومازال قابلًا لأن يُقرأ قراءة تأويلية لصالح المرأة، ولذا عادت حُسن عبود لتنفي
نسبة التحيز الذي أثبتته في قوله سبحانه:
{وَلَيْسَ
الذَّكَرُ كَالأُنثَى}
لتخبرنا بأنه مراعاة لعرف اجتماعي وليست كلمة الله النهائية على حد وصفها.
القراءة التأويلية البديلة:
كل تلك العيوب والنقائص الاستشراقية والنسوية التي ألصقتها حُسن عبود بالنص القرآني
لم تدفعها لنبذه والتخلي عن فكرة استثماره وتوظيفه، ولذا طرحت المؤلفة تأويلًا
بديلًا يجعل النص ينطق بقيم العصر الحداثي ويشهد للأفكار النسوية الغربية، عبر عدة
تأويلات منها:
1-
قوة التسمية والنسب الأمومي:
ترى المؤلفة أن منح القرآن قوة التسمية لامرأة عمران والتي أعطيت بالمثل لمريم التي
ألحقت ابنها باسمها ليصبح نسب الأم هو الذي يُذكر به اسم عيسى عليه السلام،
«إذ
إن آل إبراهيم ومن ضمنهم بنو إسرائيل الذين يعودون إلى نظام أبوي ليسوا وحدهم في
هذا الاصطفاء، وهذا ما قد يثير حساسية بين القيم الأبوية والقيم الأمومية التي أفضل
ما صُوِّرت في الصلاة القرآنية التي تتناص مع صلاة التعظيم المريمية اللوقاوية في:
{اللّهُمَّ
مَالِكَ الْـمُلْكِ تُؤْتِي الْـمُلْكَ مَن
تَشَاءُ}
[آل
عمران:
26]
وهو دعاء لقلب الموازين ربما لمصلحة النسب الأمومي الذي له شرعية النسب الأبوي».
وتبالغ المؤلفة في تأويلها فتقول: «إن مريم تعطي صورة آسرة لقوة الأمومي الذي
يستطيع أن يربط الذرية بعضها ببعض في النسب العائلي الديني، بمعنى تأسيس نسب أمومي
له اصطفاؤه كاصطفاء آل إبراهيم، فإن كان سؤال الخصب في سورة مريم هو الجواب عن
السؤال الأبدي لجدلية الموت جدلية الحياة بين العقم والذرية، فإن مفهوم الأمومة في
سورة آل عمران هو الجواب عن توالد النصوص المقدسة من الكتاب السماوي كما الذرية
النبوية بعضها من بعض من أصل واحد هو الأم، فأرحام
(الأمهات)
و(أم
الكتاب)
هي واحدة في أصل العائلة المقدسة وأصل العائلة السماوي، وهذه الصورة المجازية رائعة
بالنسبة إلى إبراز
(دور
الأم المقدس)
الذي يقع في صميم النسب الأمومي لآل عمران».
على أن المؤلفة لا تحتفي بالمرأة الأم إلا بما يخدم قضيتها النسوية فتضيف: «وقد
ينظر التحليل النسوي المعاصر إلى هذه الفكرة القديمة بعين الناقد لأنها تحد المرأة
في دور الخصوبة وتصور المرأة أمام الطبيعة والجوهري الذي فيها، إلا أننا سنرى في
سورة لاحقة صورة المرأة أمام الاجتماعي والمركب حين تناقش مسألة قبول الأنثى في
المحراب».
وهذه الصورة المتلائمة مع المزاج النسوي هي ما تولت المؤلفة بيانه في النقطة
التالية.
2
- إسقاط الفروق بين الذكر والأنثى:
ترى المؤلفة أن قبول مريم في المحراب خروجًا عن العرف السائد يلغي الفروق
الاجتماعية بين الجنسين، كما أن قصة الطواف والسعي في شعيرة الحج تربط برمزيتها بين
نظام أبوي يمثله الطواف في قصة إبراهيم عليه السلام ونظام أمومي يمثله السعي في قصة
أم إسماعيل عليه السلام، و«هذه المحاكاة للتجربتين الأبوة والأمومة معًا تجعل الرجل
والمرأة يعيشان لحظة الطواف والسعي بتبادل الأدوار وعيًا
(بالآخر)
وأهمية تجربته، وهي قمة المساواة بين الجنسين في الإسلام».
وتبادل الأدوار هنا يُقرأ في ضوء المصطلحات النسوية التي لا ترى أن للمرأة دورًا
جوهريًّا والتي تجسدت في عبارة اتفاقية السيداو الشهيرة
«الأمومة
وظيفة اجتماعية».
3
- مساواة النبوة:
ترى المؤلفة أسوة بنسويات أخريات أن التفسيرات الذكورية التاريخية والنسبية أبقت
صورة الزواج التراتبي الذي يمنح الرجل القوامة والحق بالطلاق وغيره، وأسهمت تلك
التفسيرات في إزاحة المرأة عن السلطة، ومنها التفسير القائل بعدم نبوة مريم،
«فبإقصاء
مريم من النبوة قد أقصى هؤلاء المفسرون النساء من سلطة دينية تتعلق بالتفسير الذي
ساوى بين الرجال والنساء فتوارت الشخصية المريمية إلى خلف الحدث القرآني».
وعليه فقد تولت المؤلفة نقد تلك التفاسير وإظهار تحيزها ضد المرأة لعدم قول مفسريها
بنبوة مريم، كما سجلت إعجابها بتفسير ابن حزم رحمه الله لنبوة مريم واعتبرته
نسويًّا، ودفعت فكرة اقتصار النبوة على الرجال.
وترى المؤلفة أن
«عرض
مسألة نبوة مريم وتقديم الحجج على إثباتها والعصر ليس عصر نبوات له ما يبرره»،
وهو بيان مقام مريم الرفيع في الإسلام، وتوظيف هذه المعرفة لتعزيز حقوق المرأة ومن
أهمها المساواة مع نظيرها الرجل.
تهافت الأسس المعرفية للقراءة التأويلية البديلة للقرآن:
ذكرت حُسن عبود في خاتمة كتابها أنها لم تكن مهتمة بالمواقف المختلفة من النظريات
التي استخدمتها في دراستها ما دامت تلك النظريات قد آتت أكلها.
والواقع أن فرارها من مناقشة تلك النظريات يعود لتهافت أسسها المعرفية ولعدم
ارتقائها لمنزلة البراهين العلمية.
واللجوء إلى النظريات الفضفاضة والفرضيات غير المبرهنة هو في واقع الأمر نقل
للمناهج الوضعية من حقل العلوم التجريبية إلى حقل العلوم الإنسانية برغم اختلاف
الموضوع في كل من الحقلين؛ ولذا لا يمكن فصل الأساس الفرضي للمناهج الغربية في
العلوم الاجتماعية عن المنظومة الفكرية للحداثة بوجه عام، ولا عن النزعة الإنسانوية
بوجه خاص، فما دام الإنسان يحتل مكانة مركزية في المعرفة والتفسير فله أن يبتكر
أدواته ومناهجه استنادًا للمرجعية الإنسانوية ذاتها.
وينسحب هذا على فلاسفة ما بعد الحداثة الذين يقفون ضد المركزية الإنسانية فقد
ابتكروا هم أيضًا فرضيات وطرحوها وفسروا بها الظواهر الكبرى كظهور ثقافات واندثارها
دون أي يستدلوا لفرضياتهم بأي برهان علمي.
ومن أبرز المفاهيم الإجرائية المستخدمة في النقد النسوي ما يعرف بـ«النظام الأمومي»
السابق على النظام الأبوي، وهذا المفهوم لا يعدو كونه مجرد فرضية، مما حدا بـ«غيردا
ليرنر» للقول في بحثها الذي استغرق إنجازه سبع سنوات:
«إن هجر البحث عن ماض داعم
(البحث
عن النظام الأمومي)
هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، ذلك أن إبداع أساطير تعويضية عن الماضي البعيد
للنساء لن يحررهن في الحاضر والمستقبل».
وبناء على ما سبق تقترح ليرنر تغيير السؤال من البحث عن النظام الأمومي إلى البحث
في تاريخ النظام الأبوي، لكنها وبرغم حرصها على عدم السقوط في فخ التبسيط بتخليها
عن التفسيرات التي ترجع الأمور لعامل واحد، فقد اعترفت ليرنر بأن ما تقدمه مجرد
فرضية بقولها:
«يهدف
البناء الفرضي الذي سأقدمه إلى أن يكون واحدًا من بين عدد من النماذج الممكنة فحسب».
كما أشارت مؤلفة كتاب «الكأس المقدسة وحد السكين» إلى الجدل الدائر في الغرب حول
وجود نظام أمومي وعلقت قائلة:
«ثقافتنا تتميز بمبدأ
(إذا
لم يكن هذا فسيكون ذاك)،
وهو مبدأ حذر الفلاسفة القدماء من أنه قد يؤدي لقراءة مغلوطة حتى لأبسط الوقائع».
وبرغم محاولة صاحبة كتاب الكأس المقدسة صياغة نظرية تمسك بها العصا من المنتصف
بتمسكها بفرضية وجود نظام أمومي لكنها لم تستطع أكثر من القول بأن الحفريات لا تدل
على سيطرة حقيقية للأم، بل كان المجتمع الأمومي مجتمعً تشاركيًّا، وتضيف:
«ولا
يعني هذا أن الرجال كانوا يعاملون كتابعين أو يعتبرون تابعين لأن كلًا من الرجال
والأطفال كانوا أطفالًا للآلهة كما هم أطفال المرأة التي ترأست العائلات والعشائر،
وفي حين أن هذا الأمر أعطى النساء مزيدًا من القوة فإن مشابهتنا للعلاقة التي تقوم
اليوم بين الأم وطفلها تدعونا للاعتقاد بأن هذه القوة كانت قوة ترتبط بالمسؤولية
والرعاية أكثر من ارتباطها بالقمع والامتياز والخوف».
ومن جهة أخرى، استخدمت «روث رودد» مفهوم النظام الأبوي بوصفه أداة تحليلية رئيسة في
نقدها النسوي للثقافة الإسلامية والتي تصنفها النسويات ضمن الثقافات الأبوية بلا
جدال، وكان أن توصلت رودد في دراستها حول النساء في التراجم الإسلامية إلى نتائج
إيجابية فيما يتعلق بأهمية ما يسمى بالنسب «شبه الأمومي» في التراجم الإسلامية
برهنت عليه رودد من خلال عدة نتائج تتلخص في الاهتمام بنسب الشخصية المترجم لها من
جهة المرأة
(الأم،
والجدة
...)،
لكن رودد لم تدعِ ما ادعته حسن عبود من أن هذا النسب كان غالبًا على الثقافة
العربية قبل الإسلام، بل شككت وذكرت الشكوك المحتفة بأحد الأعمال المصدرية القائلة
أصلًا بوجود نظام أمومي في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ومنها كتاب روبرتسون سميث
«الزواج والقرابة في الجزيرة العربية القديمة»، والذي لا يزال مؤثرًا إلى اليوم
بحسبها، فتقول:
«وغالبًا
ما تهمل حقيقة أن تحليل سميث الرائع دون شك يفتقر إلى دليل ملموس، وكما أشار
متخصصون في الإسلاميات في زمانه إلى أن تأويله لبعض الحقائق موضع شك».
وقد سبق وأن شككت كذلك الفليسوفة الوجودية «سيمون دي بوفوار» في هذه الفرضية من
الأساس في كتابها الموصوف بـ«إنجيل الحركة النسوية»، إذ ذكرت فيه هذه الفرضية التي
عرضها باشوفين، ونقلها عنه إنجلز معتبرًا أن الانتقال من عهد سيطرة الأم إلى عهد
سيطرة الأب انكسار تاريخي كبير للجنس النسائي، وقد سخرت سيمون دي بوفوار من افتراض
وجود سيطرة حقيقية للنساء في الأزمنة البدائية فالمجتمع كان دومًا مذكرًا والسلطة
السياسية كانت بأيدي الرجال، وتؤكد ذلك بقولها:
«والحقيقة أن هذه الفترة الذهبية من تاريخ المرأة ليست سوى أسطورة».
كما ذكرت باحثة نسوية أمريكية من أصول عربية، وهي زينب البحراني أستاذة الفنون
القديمة وعلم الآثار في جامعة كولومبيا ما توصلت إليه عبر تخصصها في علم الآثار
ودراساتها ومشاركاتها الميدانية الحديثة في التنقيب الأثري في كل من العراق وسوريا،
أن العودة النسوية إلى ماضٍ أمومي متخيَّل ومكتنز بقيم مثالية هو ما قاد الباحثات
النسويات الغربيات إلى الشرق الأدنى وإلى بلاد ما بين النهرين باعتبار هذه المناطق
تمثل حدود الزمن التاريخي ومنها ينبع التاريخ بحسب الرواية التاريخية المعروفة، ومن
هنا تجسدت أهمية استرجاع تصاوير الإلاهات الأنثويات بوصفها الدليل على النفوذ
القديم للمرأة، ومثلت هذه التصاوير والتماثيل البرهان الأركيولوجي
(الأثري)
الذي يجري الاستشهاد به من قبل الباحثات النسويات لإثبات وجود نظام أمومي في الماضي
تنتفي فيه التراتبية وتتحقق المساواة ويمكِّنهن من الإطاحة بما هو قائم، فإثبات
وجود هذا النظام بوصفه حقيقة تاريخية في العصر القديم يمكن النسويات من إظهار
الاضطهاد الواقع على المرأه باعتباره وضعًا تاريخيًّا طارئًا وليس حالة طبيعية، لكن
الحجج الأثرية التي ساقتها النسويات لم تسلم من الانتقادات، وقد ذكرت الباحثة
جانبًا من الانتقادات الغربية الموجهة للحجج الأثرية التي تسوقها الباحثات
النسويات، ومن تلك الانتقادات المنهجية الانتقائية المتمثلة في إهمالهن التماثيل
الصغيرة التي جمعت بين المقدس والمدنس في الأنثى والتي لا تخدم فكرة الأنثى
المقدسة، وقالت:
«في كل الانتقادات المذكورة رُفضت فكرة إسباغ صفة الألوهية على تلك التماثيل،
وعُدَّ ذلك مجرد أسطورة معاصرة، فلا توجد أية أدلة أركيولوجية على أن تلك المجتمعات
القديمة كانت في واقع الأمر أمومية، كما لا توجد أية أدلة على أن تلك الإلهات كُنَّ
يُعبدن على نحو حصري، وإذا كانت تلك التصاوير هي فعلًا للإلهات، فبالإمكان القول أن
الآلهة الذكور كانوا يُعبدون في الوقت نفسه مع الإلهات الأمهات».
وينتظم موقف هذه الباحثة ضمن الموقف النقدي الغربي للنظام الأمومي والدائر داخل
الدائرة النسوية وما بعد النسوية الرافض للنظام الأمومي ما قبل التاريخي والذي
اعتُبر بُنية أسطورية عُدَّت هي ذاتها جزءًا من سردية النظام الأبوي الذي ترغب
النسويات بالإطاحة به.
والمفارقة الباعثة على التأمل أن الباحثات النسويات في العالم الإسلامي لم يساورهن
شكٌ حيال تلك الفرضيات التي كانت محلًا للشك في البيئة الثقافية المنتجة لها، بل
أخضعن التراث الإسلامي بمجمله لهذه الفرضيات الواهية كفاطمة المرنيسي التي بنت
مقولاتها في كتاب «ما وراء الحجاب:
الجنس كهندسة اجتماعية» على مقولات سميث، بل سحبها بعضهن على لغة النص القرآني
نفسه، والذي يبقى ما ورد فيه حول موقع كل من الذكر والأنثى «موضوع مساءلة» كما ذهبت
حُسن عبود في قراءتها التأويلية للقرآن، أما الفرضيات العاملة في خطابهن فقد
أخرجنها من نطاق المساءلة، برغم وعي بعض النسويات بالمآلات الخطيرة المترتبة على
القول بالنظام الأبوي الذي ربطنه بالأديان السماوية واعتبرن رفض أحدهما رفضًا
للآخر، وقد تجلى هذا في ثورة النسويات على اللغة التي كُتبت بها الكتب المقدسة
والمتأثرة بذلك النظام المعبِّر عن الله بوصفه
(مذكرًا)
-
برأيهن
-
والمطالَبة بإعادة صياغتها واستخدام ضمائر محايدة، وقد تحققت هذه المطالبة في عام
1994م
بإصدار نسخة جديدة من الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) سميت بالطبعة
المصححة، حيث استخدمت فيها الضمائر المحايدة، وانتهى رفض النظام الأبوي بطائفة من
اللاهوتيات المسيحيات إلى رفض فكرة «الله» أو الإلحاد بصفة أدق عند وصولهن إلى
مرحلة «ما بعد الأبوية» في مسيراتهن الفكرية، كما وصل الحال بمعظمهن إلى رفض
العلاقات الطبيعية بين الجنسين والحمل والولادة باعتبارها مؤسسات أبوية تستعبد
المرأة.
الحصاد المرتقب للقراءة الأدبية للقرآن:
ظهر الاتجاه الداعي لعلمنة الدين في الغرب كما هو معروف، ومن أبرز الدعوات الغربية
الحديثة للتصالح مع الدين عبر علمنته دعوة «هابرماس»، التي وردت في كتاب «قوة الدين
في المجال العام»، والتي طالب فيها المتدينين بترجمة الإمكانات الدلالية القادمة من
التقاليد الدينية إلى لغة علمانية وإلى لغة متاحة للجميع.
وعلمنة الإسلام بإخضاع القرآن لمصير مشابه للتوراة والإنجيل، مما يدخل في صميم
اشتغالات الاتجاه النسوي في العالم الإسلامي، والقراءة الأدبية للقرآن ليست إلا
طريقًا من طرقه.
ووحده الساذج من تخدعه التصريحات الغربية حول استنارة الإسلام، ويظنه تحولًا في
الموقف الاستشراقي من الإسلام كتصريح أنجليكا وينفرت الذي ذكرت فيه أن
«ادعاء
افتقار الإسلام إلى التنوير، كليشيه غربي قديم».
ويذكرنا هذا التصريح بما ذكره الباحث المغربي رشيد بو طيب في مقالته المشار إليها
سابقًا والتي ذكر فيها أن ما تقوم به أنجليكا نويفرت لا يختلف عما يقوم به هابرماس
في مطالبته للمتدينين بترجمة لغتهم إلى لغة دنيوية، ويرى بو طيب أن هذه المطالبات
تلغي الآخر لكن باسم الديموقراطية.
ولا نحتاج إلى طويل تأمل لندرك خدمة القراءة الأدبية للطرح السابق واشتباكها معه،
فحُسن عبود تكرر مقولة أمين الخولي لتؤكد أن القراءة الأدبية للقرآن يجب أن تتقدم
على كل دراسة أخرى، وبعبارة أخرى تقدم بوصفها بديلًا عن التفسير التقليدي للقرآن
«فالقرآن
الكريم بكلام الشيخ أمين الخولي هو كتاب العربية الأكبر الذي يحتاج إلى تجاوز
المنهج التقليدي للمفسرين».
ودعوة الخولي مع الأسف جعلت تفسير القرآن
«أرضًا
مباحة لكل ذي علم أو جهل ولكل ذي نحلة إلهية أو بشرية»
كما قال الباحث المغربي حسن بوتبيا في كتابه «القراءة الأدبية للقرآن».
ويجب أن ندرك هنا أن القراءة البديلة التي قدمتها حُسن عبود ليست هدفًا أدبيًّا ولا
معرفيًّا بحتًا، وإنما وسيلة لتغيير البُنى والمفاهيم الذهنية، وما يترتب عليها من
تغيير اجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين.
ومما يجب استحضاره هنا أن القراءة الأدبية وسيلة لتذويب الهوية الإسلامية عبر ما
يسمى بالحوار المسيحي الإسلامي، وهذا ما لم تعلنه المؤلفة الناشطة في هذا الحوار،
ومما ذكرته في ثنايا كتابها في هذا الشأن إشارتها لأهمية استثمار الإشارة المريمية
في القرآن كما وجه لذلك المستشرق لويس ماسينون، ولذا فالحفاظ على التميز العقائدي
الإسلامي فضلًا عن إبرازه ليس هدفًا يشغل المؤلفة بل تهدف المؤلفة لتوظيف دراستها
في البحث عن المشتركات أو عن كل ما يشي بالذوبان القرآني في المسيحية فتقول بلغة
استشراقية تذكرنا بلغة المستشرق بلانشو:
«في
بحث كهذا ليس مهمًا أن نستخدم قواميس اللغة السامية وغير السامية فحسب، إنما من
المهم أيضًا أن نعترف بالتراث الشعائري والأدبي المشترك والذي بدا لنا أن القرآن
يستحضره في الصلوات والترانيم والقصص».
وتدعي المؤلفة أن سورة آل عمران تحتوي مصطلحات وأنغامًا مسيحية وتعبر عن إعجاب خافت
بالديانة المسيحية، ثم تذكر أن الآيات التي تمثل الحجاج في سورة آل عمران لا يمكن
أن تكون موجهة للنصارى، والحجاج في السورة يتوجه لفئة واحدة من الذين أوتوا الكتاب
هي اليهود لأن القرآن عبر عن إعجاب بشخصيات مسيحية كامرأة عمران وزكريا ومريم
وعيسى، أما الذين كفروا فيراد بهم اليهود ومشركو العرب، ولهذا تشدد حُسن عبود على
أهمية التناص في سورة مريم لأهميته اللاهوتية والروحية والنسوية.
منهجية التأليف بين المتنافرات وحصاد الهشيم:
برغم انطلاق حُسن عبود من مقولات أنجليكا نويفرت التي لا تعترف بالمصدر الإلهي
للقرآن، وتنبني نظريتها التأويلية للقرآن على بشرية القرآن وسائر الكتب المقدسة،
فقد حاولت المؤلفة استثمار النظرية الأنجليكية مع استبقاء لفظي للصفة السماوية
للقرآن، والواقع أن تطبيق نظرية أنجليكا كما لاحظنا أعلاه يعود بالمؤلفة للقول
بمقدمتها، أي إلى تأكيد بشرية القرآن وكونه محض منتج ثقافي، وهو ما استفرغت المؤلفة
جهدها في تأكيده واصطناع شواهده صفحة بعد صفحة، وهذا التناقض الكبير هو نتاج
التلفيق بين مقولتين متضادتين هما المقولة الإسلامية التي تعتبر القرآن كلام الله
المحفوظ من التغيير والتحريف والتبديل والمقولة الاستشراقية القائلة بالعكس تمامًا.
كما أن المؤلفة عرضت الاختلاف بين القرآن التوراة والأناجيل بجميع نسخها المعترف
بها والمنحولة وكأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وتتحدث عن الأناجيل وكأنها تنقل
روايات متعددة من كتاب واحد، وتشير إلى السلالة الواحدة للكتب السماوية مرة بعد مرة
دون تمييز مطلقًا بين الرواية الموثوقة للقرآن وبين التوراة والإنجيل بوصفهما
كتابين محرفين، وإذا ما تجاوزنا النقد الإسلامي لفكرة التسوية بين القرآن والكتب
المحرفة واكتفينا بالرد على هذه الفكرة من الأدبيات الاستشراقية الغربية، فالفرق
بين تلك الكتب والقرآن نجده لدى المستشرق «موريس بوكاي» الذي انتهى في كتابه
«التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» إلى أن التوراة عبارة عن أعمال أدبية كتبت على
مدى فترة زمنية تقارب تسعة قرون بأيدي كتاب متعددين مما أدى لتغير مضامينها، وشبهها
بفسيفساء تفتقد الانسجام، وأما الأناجيل الأربعة فهي برأيه كتابات أشخاص لم يعاصروا
المسيح ولم يشاهدوا أفعاله، وكُتب بعضها بعد زمن طويل من وفاة المسيح، فظهرت في تلك
الكتابات تناقضات بحسب ميول كل كاتب، بخلاف الوحي القرآني الذي نزل على مدى عشرين
عامًا وتم تسجيله وكتابته أثناء حياة الرسول صلى الله وعليه وسلم، وتم تدقيقه من
قبل عثمان رضي الله عنه مما يجعل للقرآن أصالة بين الكتب السماوية الأخرى.
أما الأناجيل المنحولة فيكفي فيها تعريف المؤلفة نفسها لها بأنها تعرف بالكتابات
المنحولة أي الكتابات الخفية المكتومة، وهي التي لم تعترف الكنيسة لا بأصالتها ولا
بقانونيتها وتميل إلى التفاصيل والتضخيم بالأفكار والأعاجيب الخارقة.
ولا شك أن هناك فرقًا بين كون القرآن
{مُصَدِّقًا
لِّـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ}
[المائدة:
48]
وبين أن يكون ناقلًا عنهما أو أحدهما مع اختلاف تفترق فيه الكتب في الخواتيم.
وما فعلته مؤلفة كتاب «السيدة مريم في القرآن الكريم»، هو محاولة بائسة لزحزحة
القرآن من مكانته بوصفه مهيمِنًا على الكتب السابقة ليصبح مهيمَنًا عليه من قبلها.
وهذه الزحزحة يردها ما ذكره أهل العلم في قوله تعالى:
{وَأَنزَلْنَا
إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْـحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ}
[المائدة:
48]
«أي
حاكمًا على ما قبله من الكتب»،
قاله ابن عباس رضي الله عنه.
وقال الفخر الرازي رحمه الله:
«إنما
كان القرآن مهيمنًا على الكتب لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخًا البتة، ولا يتطرق
إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى:
{إنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ
لَـحَافِظُونَ}
[الحجر:
٩].
وقال ابن تيمية رحمه الله:
«السلف
كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب».
والهيمنة البديلة التي اصطنعتها المؤلفة لتلك الكتب المحرفة، تتبعها هيمنة الثقافة
الغالبة ليصبح القرآن ناطقًا بثقافتها شاهدًا لنظمها وقيمها، ومنها قيم النسوية
التي وصفتها المؤلفة في أحد بحوثها بالعقيدة، لا ليكون القرآن شاهدًا عليها فضلًا
عن أن يكون حاكمًا عليها.
وما أحسن ما قاله مصطفى الرافعي رحمه الله في كتابه «تحت راية القرآن» ردًا على
القراءة الأدبية الأولى للقرآن التي اجترحها طه حسين: «إن القرآن عند هذا الرجل
كتاب أشبه بالكتب التي يضعها المؤلفون فتكون تمثيلًا للعصر الذي وضعت فيه لأنها
صادرة عن فكر متأثر بالأسباب الكثيرة التي أنشأت العصر نشأته الخاصة والمميزة له،
مؤثرة بهذه الأسباب عينها فيما يضعه ويؤلفه، كما ترى في إلياذة هوميروس مثلًا،
وإذًا فلم يبق معنى لما ورد فيه من أنه {لا
يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ}
[فصلت:
42]
ويلتحق هذا بالأساطير التي استغلها الإسلام لسبب ديني»، ثم بَّين الرافعي ما تعنيه
هذه الآية التي وصفها بالبلاغة المعجزة بقوله: «إن معناها يا أستاذ الجامعة أن
القرآن لا يشخِّص عصرًا ولا يمثله، بل هو كتاب كل عصر، وهو الثابت على كل علم وكل
بحث وكل اختراع واستكشاف على مرِّ الأزمنة، في أيها جاء مما يستأنفه التاريخ وهذا
معنى {مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ}،
وأيها ذهب مما يطويه الماضي، وهذا معنى {مِنْ
خَلْفِهِ}،
وليس يخفى أن العصور يصحح بعضها بعضًا ويكشف بعضها خطأ بعض، وقد يتقرر في زمن ما
يثبت بعد أزمان طويلة أنه كان خطأ، فقوله {لا
يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلا مِنْ خَلْفِهِ}
من الكلمات التي لا تخطر بفكر إنساني يظن أنه يشخص العصر الجاهلي، بل هي علم من لا
يعلم غيره أن ستجدُّ أمور، وتحدث علوم، وتمحص تواريخ، وتنشأ مخترعات، فلو فهم
الجاهل لما تكلم إلا الفاهم، وقد قال الله في أشباه طه حسين:
{وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا}
[يونس:
13]».
:: مجلة البيان العدد 337 رمضان 1436هـ، يونيو - يوليو 2015م.
[1]
حول مفهوم الجندر وآثاره التطبيقية على القرآن، راجع مقالة: «القراءة الجندرية
للقرآن ومقالات التسول الثقافي»، لملاك الجهني على موقع نماء للدراسات والبحوث على
الشبكة.