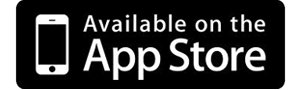من حجج القرآن في التراث التيمي
بلغ هوان الوحي وانتقاصه عند فلاسفة الإسلام أن جعلوه مجرد خطاب تخييلي، أو أسلوباً للعامة، وأن الرسل عليهم السلام يكذبون لمصلحة العامة والجمهور!
وقاربهم متكلمة الإسلام الذين لا يقبلون الوحي إلا عقب انتفاء المعارضات العقلية، والخطرات الذهنية، وإذا جاء الوحي بما لا يروق لهم تديّنوا بتحريف، وكدّ الأذهان بليّ نصوص الوحي عمّا دلت عليه، وحشدوا لأجل ذلك التأويلات المتكلفة وأجلبوا شواذ اللغة وغريب المعاني ليتسنى لهم التحريف والتبديل، أو سلكوا سبيل التجهيل والتضليل، فجعلوا نصوص الوحي ألفاظاً لا معنى لها!
وفي هذا الواقع القاتم يتجلى التراث السلفي على يد ابن تيمية - رحمه الله - ويبرز منهج أهل السنة بتأصيله وتحقيقه، واطراده ويقينه، وحججه وبراهينه، فقد أظهر أبو العباس بن تيمية ما في الوحي من الغَناء والشفاء، وبرد اليقين وحلاوة الإيمان، وبيّن ما في الوحي من الدلائل الكافية والبراهين العقلية الوافية، وأن في القرآن الجواب عن كل بدعة وباطل قديماً وحديثاً ومستقبلاً، قال تعالى: {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إلَّا جِئْنَاكَ بِالْـحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: ٣٣]؛ قال ابن تيمية: «القرآن قد دلّ على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها»[1].
وقد فتح الله على أبي العباس فتوحات جليلة في باب المخاطبات والمناظرات والمحاورات، ووهبه الله قدرة هائلة على انتزاع الآيات والاحتجاج بها في الرد على المخالفين، بل جزم أن كل دليل نقلي أو عقلي يحتج به أيّ مبتدع لبدعته، فإنه في الحقيقة والواقع حجة عليه، ودليل ينقض بدعته. كما هو مبسوط في موضعه.
ومن براعته الفائقة، ودقته الباهرة: احتجاجه بالآية الواحدة من كتاب الله في الرد على القولين المتضادين، وإظهار تهافت أصحاب المقالات المتقابلة من خلال الاحتجاج عليهم بآية واحدة في مسائل كثيرة ومطالب متعددة، كما هو مبيّن في الأمثلة التالية:
١- قال تعالى: {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِـمَن يَشَاءُ} [النساء: 48]، ومن المعلوم أن في هذه الآية رداً على المعتزلة والخوارج الزاعمين أن من مات على ذنوبه غير تائب منها فهو مخلد في نار جهنم، فإن الآية أثبتت مغفرة لمن يشاء الله له من عصاة الموحدين[2]، فليست الآية في حق التائبين، كما تزعم المعتزلة؛ فإن التائب عن الشرك يغفر له الشرك أيضاً، وكذا ما دون الشرك فإن الله يغفر لكل من تاب[3].
والحاصل أن في الآية رداً على الوعيدية كما هو معلوم عند الأكثرين، لكن قد تخفى دلالتها في الرد على الفرقة المقابلة لهم، وهم المرجئة، فلقد أشار ابن تيمية إلى جواب لطيف وردّ متين على المرجئة من خلال هذه الآية، فقال: «قد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما تردّ على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فهي تردّ أيضاً على المرجئة الواقفية[4]، الذين يقولون يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع، فإنه قال: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِـمَن يَشَاءُ} فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: {لِـمَن يَشَاءُ} فلما أثبت أن يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء دلّ ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها لبعض الناس»[5].
٢- قال الله تعالى: {وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى 11 الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى 12 ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى 13 قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى 14 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 15 بَلْ تُؤْثِرُونَ الْـحَيَاةَ الدُّنْيَا 16} [الأعلى: ١١ - 16] وبيّن ابن تيمية أن هذا الصلي قد فسّره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناساً أصابتهم النار بذنوبهم، فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة...». فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماً، ثم يشفع فيهم فيخرجوا.
وفيه الرد على طائفتين: على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد يخلدون فيها. وهذه الآية حجة عليهم، وعلى من حُكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد.
وفيه رد على من يقول: يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النار، كما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة، ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة - وهم الواقفة من أصحاب الأشعري كالقاضي الباقلاني وغيره - فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم[6].
هذا المسلك الفريد في الاحتجاج والجدال يجلي ما عند أبي العباس من تحري العدل ولزوم الوسط بين الإفراط والتفريط، والاطراد في هذا النهج، كما يكشف سعة أفقه ورحابة تأصيله ونقده، فلم يستغرق في مدافعة انحراف وإهمال ما يقابله، ولم تستحوذ عليه مدافعة الغلو دون مدافعة الجفاء والتقصير.
٣- قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، هو ردٌّ على طائفتين متقابلتين: المعتزلة القدرية، والجهمية والأشاعرة الجبرية، فالمعتزلة يجوّزون التعذيب قبل إرسال الرسل؛ لأنه فعل القبائح العقلية، والآية تنقض هذه المقالة، فإن الله تعالى لا يعذّب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة، كما أن في الآية ردّاً ونقضاً لمذهب الجبرية القائلين بأن الله يعذّب من لم يفعل قبيحاً قط كالأطفال، والآية تبطل أيضاً هذا المذهب؛ فحكمة الله ورحمته تأبى ذلك، فإنه لا يعذب أحداً بلا ذنب، كما بسطه ابن تيمية في عدة مواطن[7].
٤- قوله تعالى:{لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ 28 وَمَا تَشَاءُونَ إلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 29} [التكوير: 28، 29]، فقد أظهر أبو العباس دلالة الآية في الردّ على الجبرية والقدرية حيث قال - رحمه الله -: «وهذه الآية رد على الطائفتين المجبرة الجهمية، والمعتزلة القدرية، فإنه تعالى قال: {لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ} فأثبت للعبد مشيئة وفعلاً، ثم قال: {وَمَا تَشَاءُونَ إلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} فبيّن أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله»[8].
- وقريب من ذلك احتجاجه بقوله تعالى:{فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} في الرد على القدرية حيث أثبتت القدر بقوله {فَأَلْهَمَهَا}، وفيه الرد على الجبرية من جهة إثبات فعل للعبد، حيث أضاف الفجور والتقوى إلى نفس العبد، وفيه أيضاً رد على الجبرية من جهة التفريق بين الحسن والقبيح في قوله: {فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}[9].
- ويلحق بذلك أيضاً قوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا 78 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ} [النساء: 78، 79]، ففيه ردّ على القدرية النفاة حيث جعل الحسنات من الله، كما جعل السيئات من عند الله، كما في قوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّه} ، وفيه ردّ على الجبرية في قوله سبحانه: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} فالإنسان هو فاعل السيئات، ويستحق عليها العقاب[10].
٥- قوله سبحانه: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] حيث وضّح أبو العباس أن في الآية رداً على الجبرية حيث أثبتت للشخص كسباً، كما أن فيها نقضاً لمذهب أهل الإحباط والتخليد (الوعيدية من الخوارج والمعتزلة) حيث لم يبطل كسبُه اكتسابَه، ولم تحبط سيئاتُه حسناتِه بإطلاق، وأولئك يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسب[11].
٦- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ 87 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا} [المائدة: 87، ٨٨] فيه الرد على أهل التشدد والغلو، وأهل الانحلال والانفلات، فإن أهل السنة وسط بين أصحاب الفجور والفواحش، وأصحاب الرهبانية والإفراط حيث بيّن ابن تيمية معنى الآية فقال: «نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات، وعن الاعتداء في تناولها، وهو مجاوزة الحد، وقد فُسّر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم، وقيل: لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس، فإن أكل الطيبات والشهوات المعتدي فيها لابد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك»[12].
٧- ونختم المقالة بمثال من السنة النبوية، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه»[13].
ففي هذا الحديث رد على المعتزلة نفاة القدر من وجهين كما بسطه المؤلف بقوله: «أحدهما: أن عند المعتزلة لم يولد أحدٌ على الإسلام أصلاً، ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافراً، ولكن هذا أحدث لنفسه الكفر، وهذا أحدث لنفسه الإسلام، والله لم يفعل واحداً منهما بلا نزاع بين القدرية.
الثاني: أنهم يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل، فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية، أو تكون من فعل الله تعالى»[14].
ويمكن أن يقال إن في الحديث رداً على الجبرية، فإن الله قدّر الشقاوة والسعادة وكتبها، كما في آخر الحديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين»، وقدّر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها، كفعل الأبوين، فتهويد الأبوين وتنصيرهم وتمجيسهما هو مما قدّره الله[15].
والحاصل أن هذه الفتوحات الهائلة، والنوادر الباهرة لابن تيمية لا تكاد تنتهي ولا تنقضي، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
وهاك وصفاً بليغاً مدهشاً لمجالس ابن تيمية في التفسير كما يصفها تلميذه البزار بقوله:
«كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن يشرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها. وكان مجلسه في وقت متعدّد مقدّر بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معيّن يقرأ له شيئاً معيّناً يبيّته ليستعد لتفسيره[16]، بل كان من حضر يقرأ ما تيسر، ويأخذ هو في القول في تفسيره، وكان غالباً لا يقطع إلا ويفهم السامعون أن لولا مضيّ الزمن المعتاد لأورد أشياء أخرى في معنى ما هو من التفسير»[17].
وأخيراً، فإن هذه المواهب الربانية والعجائب العظيمة باعثها أمران: العلم والفقه، والتذكرة والعظة، كما فصّله أبو العباس قائلاً:
«قال تعالى: (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة: تبصرة من العمى، وتذكرة من الغفلة، فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف ونسي، والإنسان يقرأ السورة مرات، حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأنها الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني، ويزداد علمه وعمله، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع الغفلة»[18].
نسأل الله علماً وفقهاً للقرآن، ويقظة من الغفلان وعظة بالآيات المتلوات والمخلوقات.
:: مجلة البيان العدد 349 رمــضــان 1437هـ، يـونـيـو 2016م.
[1] الدرء 5/56.
[2] ينظر: نكت القرآن للكرجي 1/272.
[3] ينظر: الفتاوى لابن تيمية 11/184، 16/18.
[4] المرجئة الواقفة الذين سلكوا الوقف في نصوص الوعيد.
[5] الفتاوى لابن تيمية 16/19.
[6] ينظر: الفتاوى 16/195، 196.
[7] ينظر: النبوات 2/676، الفتاوى 19/215، ومنهاج السنة 5/99.
[8] الفتاوى 8/488، وينظر: جامع الرسائل 1/70.
[9] ينظر: الفتاوى 16/243.
[10] ينظر: الفتاوى 14/246، 247.
[11] ينظر: الفتاوى 14/138، 139.
[12] الفتاوى 14/457، 458. ينظر: 10/623.
[13] أخرجه البخاري ومسلم.
[14] الدرء 8/378 = باختصار.
[15] ينظر: الدرء 8/361.
[16] فأي شخص في مجلسه يقرأ كيفما اتفق من آيات القرآن، ثم يفيض أبو العباس كالبحر بعلوم جليلة وفهوم دقيقة دون إعداد مسبق.
[17] الأعلام العلية للبزار ص744. (مع العقود الدرية لابن عبد الهادي).
[18] الإيمان ص 223، 224.